|
|
|
|||||||
| منتدى الأدب العام والنقاشات وروائع المنقول هنا نتحاور في مجالات الأدب ونستضيف مقالاتكم الأدبية، كما نعاود معكم غرس أزاهير الأدباء على اختلاف نتاجهم و عصورهم و أعراقهم . |
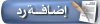 |
| مواقع النشر المفضلة (انشر هذا الموضوع ليصل للملايين خلال ثوان) |
|
|
أدوات الموضوع | تقييم الموضوع | انواع عرض الموضوع |
|
|
رقم المشاركة : 1 | |||
|
حديث الوردة .. حديث النار (1 ـ 4) قراءة في بعض الظواهر الشعرية لدى الشاعر حسين علي محمد بقلم: أ.د. حلمي محمد القاعود (1) حسين علي محمد (1950- ) واحد من أهم شعراء السبعينيات، الذين حملوا رؤية صافية نقية، تنبع من فهم واع لهوية الأمة وشخصيتها، وتحركوا من خلال تصور واثق، يؤمن بقيمة الفن ووظيفته في مخاطبة المشاعر والأفئدة، وتجييش العواطف والأحاسيس بما يجعل المتلقي، قارئا أو مستمعا، شريكا في العمل الفني بالاستجابة والتفاعل، وليس مجرد مشاهد لا يفهم أو لا يدري ما يُقال أو يُتلى أو يُقرأ. إن "حسين علي محمد" شاعر ينتمي إلى الريف المصري، وقد ظل وفيا لهذا الريف منذ مولده وحتى اليوم، يعيش مع أهله وناسه همومهم وآمالهم، دون استعلاء عليهم، أو تنكر لهم، فهو واحد منهم، يُغني أناشيدهم، ويُنشد أغانيهم، دون أن تستهويه أضواء العاصمة، أو تخلعه من جذوره، أو تجعله يبيع هويته في سوق الرق الفكري، الذي يشتري الباحثين عن الشهرة بأبخس الأثمان، وأرخص القيم. ظل حسين علي محمد في بلدته الصغيرة "ديرب نجم ـ بمحافظة الشرقية" يقرأ ويدرس ويعمل ويقرض الشعر، حتى استطاع بموهبته وخبرته ومثابرته أن يفرض أدبه وإنتاجه في معظم الصحف والدوريات التي تصدر في العاصمة، وبقية العواصم العربية، وأن يكون واحداً من شعراء زماننا الذين يُقدِّمون شعرا عذبا وجميلا، يذهب بطعم الحصرم ـ الذي نتجرّعه بالقوة والإرهاب ـ عبر الوسائط الإعلامية والأدبية، لنفر من الطغاة الذين ظنوا السخف الذي يقولونه أو يكتبونه شعراً وأدباً، وذهبت بهم الصلافة والغرور إلى الحد الذي تصوروا معه أنهم أتوْا بما لم يأت به الأوائل، وأنهم أحدثوا تطورا غير مسبوق وَصَلَ بالشعر العربي إلى ذروةٍ لم يصل إليها أحد من الغابرين! وهيهات أن يكون هذا الأمر صحيحاً، إذ لو كان كذلك ما أعرض عن كلامهم الناس، ولا وقفوا منه موقف "الأطرش في الزفة" .. ولكن الآلة الإعلامية الرهيبة تعمل على قلب الحقائق، وتوهم بالباطل بما لا أساس له في الواقع. على كل، فإن "حسين" قد نمت موهبته الشعرية من خلال دراسته النظامية التي وصلت به إلى الحصول على درجة "الدكتوراه" (عام 1990م)، وإن كنت أرى أن ثقافته الحقيقية قد نمت وتبلورت من خلال قراءاته ومتابعاته الأدبية والثقافية خارج الدرس "النظامي"، فالتثقيف الذاتي ـ فيما أعلم ـ كان وراء ذلك الوعي العميق الذي يظهر عبر قصائده وأشعاره بأبعاد التراث الإسلامي، الناضج، والواقع الراهن بملامحه المأساوية المتردية، والحلم الجميل بمستقبل أفضل من خلال تتبع ما يجري في الدنيا، ولدى الآخرين من مميزات التفوق والقوة والبناء. نحن إذن أمام شاعر يملك نضج الرؤية الحضارية على المستوى الفكري، حيث يلتقي الماضي والحاضر والمستقبل في وجدانه وعقله وخياله، وهو بهذا يستطيع إذا أنشد أن يقدم لنا شعراً ذا قيمة، وذا أصالة أيضا .. فضلا عن "الكم" الكبير الذي نشره وكتبه من القصائد والمسرحيات. نشر "حسين علي محمد" مجموعة من الدواوين أو المجموعات، بعضها بالجهد الذاتي (بطريقة الماستر)، وبعضها عبر أجهزة النشر الحكومية، وأيضا فإن لديه أكثر من مسرحية ومجموعة شعرية لم تنشر، وإن كان نشر بعض قصائدها في صحف ودوريات محلية وعربية متعددة. من المجموعات التي نشرها بجهده الذاتي"السقوط في الليل" عام 1977م، وساعده في نشرها: اتحاد الكتاب العرب بدمشق، أيضا نشر بجهده الذاتي مجموعته "أوراق من عام الرمادة" عام 1980م، ضمن دورية"أصوات" التي كان يُصدرها في الشرقية مع فريق من زملائه الشعراء والفنانين التشكيليين، وهي أسبق من الدورية الأخرى التي صدرت بالاسم نفسه بوساطة فريق آخر في القاهرة. ومن المجموعات الأخرى المخطوطة التي لم تنشر بعد: "تجليات الواقف في العراء"، و"زهور بلاستيكية"، و"من دفاتر العشق" .. وله أيضا مسرحيتان مخطوطتان: "الرجل الذي قال"، و"الحاجز الرمادي". وإلى جانب ذلك فهناك بعض الدراسات الأدبية التي نشرها الشاعر، مثل: "البطل في المسرح الشعري المعاصر"، وصدر في القاهرة عام 1991م، و"القرآن ونظرية الفن"، وقد صدرت طبعته الثانية عام 1992م. ومازال الشاعر ينشد شعرا، ويكتب دراساته ومقالاته التي تدل على أصالة وعيه العميق. (2) من يقرأ شعر حسين علي محمد يستشعر أنه بإزاء شاعر له شخصيته المتفردة في الأداء الفني والرؤية الشعرية، صحيح أننا نستشعر ملامح التقليد في البدايات ـ وهذا أمر طبيعي ـ ولكن مرحلة النضج قدّمت شاعراً يمتلك الأداة التي يستخدمها بتميز، ليعبر من خلالها عن رؤيته الصافية وحلمه المتميز. في البداية بدا الشاعر معجباً بمجموعة من شعراء التجديد المعاصرين أمثال بدر شاكر السياب، وعبد الوهاب البياتي، وصلاح عبد الصبور، وقد رثى السياب عند وفاته بقصيدة جيدة، ولكن تأثره الواضح ارتبط بالشاعر صلاح عبد الصبور، ولعل ذلك يرجع إلى شهرة الأخير في مطلع حياة حسين الشعرية، وإلحاح أجهزة الإعلام حينئذ على شعره وأخباره، ومن ناحية أخرى فلعل العامل الجغرافي كان من وراء هذا التأثر، حيث ينتمي الشاعران إلى محافظة واحدة هي محافظة الشرقية، ولعل أبرز نماذج التأثر تبدو في قصيدة حسين التي عنوانها "أربع صفحات من مذكرات أبي فراس" التي نشرها في مجموعة "السقوط في الليل"، ويقول في مطلعها: "أعودُ منْ بلادِ الثلجِ والضبابِ والرؤى المهوِّمهْ وقلبيَ الصغيرُ وزدةٌ حمراءْ تنِزُّ بالدِّماءْ أعودْ وليتني ما عدْتُ يا صِحابْ فهاهيَ الوجوهُ مُعْتِمهْ لمْ تبْتسِمْ لعوْدَتي بالحبِّ والصَّفاءْ وهاهُمُ الصِّغارُ في الأركانِ نائمونْ يحلمونَ أنْ تقومَ فوقَ أركانِ المدينةِ المُهَدَّمَهْ مدينةٌ جديدهْ مدينَةٌ سعِيدَهْ لايصدِمُ الصِّغارَ فيها منظرُ الدِّماءِ والأشلاءْ" (ص36) وإذا كنا في هذه القصيدة نستشعر صورا عديدة تذكرنا بقصيدة "صاحب الوجه الكئيب" خاصة، فإن قصيدة حسين تقودنا بوجه أخص إلى قصيدة صلاح عبد الصبور الشهيرة، التي عنوانها "الخروج"، وفيها يستلهم هجرة الرسول من مكة إلى المدينة، ليعبر عن تجربة شخصية مرَّ بها، ويقول في أحد مقاطعها: "لو مت عشت ما أشاءُ في المدينةِ المنيرهْ مدينةِ الصحو الذي يزخرُ بالأضواءْ والشمسُ لا تُفارقُ الظهيرهْ أوّاهُ يا مدينتي المُنيرهْ مدينة الرؤى التي تشربُ ضوءِا هل أنتِ وهم واهمٍ تقطّعتْ بهِ السُّبلْ؟ أم أنت حق؟ أم أنتِ حق" (الأعمال الكاملة، ص237) ولسنا هنا في مجال المقارنة والتقويم بين الشاعرين، ولكننا نشير إلى بدايات الشاعر التي تكون عادة أقرب إلى التقليد والتأثر بالآخرين، منها إلى الاستقلال والذاتية الصرفة، وهو ما صنعه الشاعر فيما بعد، رؤية وأداة. والحديث عن رؤية الشاعر وأبعادها يقضي مجالا أرحب، ولكننا نشير إليه هنا باقتضاب، لنؤكد على ما يمكن أن نسميه "الواقعية المثالية" .. حيث ينطلق الشاعر من واقعه ليطلب المثال وفق تصور واضح، لا غموض فيه ولا التباس ولا التواء. وهذا الواقع الذي ينطلق منه هو واقعه اليومي المعاش على المستوى الشخصي ومستوى الأمة. وإن كان ما يجري للأمة ويعصف بكيانها وحضارتها وتاريخها ومستقبلها يمثل العنصر الأغلب والأعم والأكثر أهمية .. قليلة هي القصائد التي تنضح بالهم الشخصي، وقليلة هي الأشعار التي تقدم لنا معالم خاصة في حياة الشاعر تشغله أو تمنعه عن التفكير في واقع الأمة ومأساتها .. إنه شاعر يعيش لأمته، وينسى نفسه إلا في حالات قليلة يمكن عدها على الأصابع، بل إنه يوظف تجاربه الشخصية لتكون معبرا يصل إلى واقع الأمة، أو صدى لواقع الأمة. من تجاربه الشخصية القليلة التي استأثرت بهمه الذاتي رثاؤه لأبيه الذي فقده، وهي مرثية قصيرة محكمة، يبدو فيها الرضا بالقدر والتسليم بالقضاء مع الإحساس الحاد بالفقد: " .. وهلْ يسمعُ الشيخُ صوْتَ الرياحِ بوادي الفناءْ أيا فرسَ الموتِ ، أقبِلْ ، وطِرْ بي ودعْهُ هنا نائماً مُستريحاً وألْقِ عليْهِ .. الرِّداءْ". وبصفة عامة فإن التجارب الذاتية تدور غالباً حول الرثاء للأحبة والأصدقاء والشعراء الذين ارتبط بهم عاطفيا وفنيا، ومن خلالها يبث شجنه، ويومئ ضمنا إلى الهم العام الذي يؤرقه ويضنيه، والذي يتفرد بالساحة الشعرية للشاعر، ويفرض ملامحه عليها، وعليه أيضا، كما نرى في قصيدة "الحصار يليق بالشاعر"، حيث يصير الشاعر "مجرَّدُ فرْضٍ في ذاكرةِ الطينِ"!: "في الشارعِ يقفُ السمسارْ في النّافذةِ المُخبرُ في الذاكرةِ بقايا النّارْ كيْفَ تُخاطبُكَ الأشجارْ يا رجلَ الأقدارْ ـ أنت مجرَّدُ فرْضٍ في ذاكرةِ الطينِ وقبرُكَ محفورٌ في الأشعارْ". ولعل هذه القصيدة القصيرة تجمع عناصر رؤيته في ذلك الصراع غير المتكافئ بينه وبين قوى الشر العاتية المتمثلة في "السمسار": رمز الانتهازية، والميكافيللية، والكسب بلا تعب، والمخبر: رمز السلطة والحصار والملاحقة .. ونتيجة الصراع واضحة سلفاً، حيث إنها محسومة لصالح الجبهة التي يقودها السمسار والمخبر .. أما الشاعر ـ رجل الأقدار ـ فمصيره إلى القبر!، وعلى الرغم من أن القصيدة تومئ إلى ملامح المقاومة والوقوف ضد التيار من خلال "بقايا النار" و"الأشجار"، وسنرى فيما بعد دلالة "النار" على صورة المقاومة والتطهير والأمل، فإن "الأحجار" بكل ما ترمز إليه من صلادة وقسوة وفقدان للإحساس، تعطي ملمحا مأساويا يُكرِّس الهزيمة والموت!! مما يعني واقعية الشاعر ومثاليته في وقت واحد. وللإنصاف فإن الشاعر على مدى تجربته الشعرية، كان الأمل يومض في أشعاره بالرغم من قتامة الواقع المحبط، والذي يتبدّى عبر تفاصيل الحياة اليومية والأحداث السياسية والاجتماعية، وظل يحلم بهذا الأمل إلى عهد قريب، ولكنه ـ فيما يبدو ـ وصل مؤخرا إلى درجة الاقتناع باليأس وعدم الجدوى، لأنه يرى ما حوله ينبئ عن الهزيمة، ويتحدث عن الموت. ولا بأس أن نورد نموذجاً للأمل الذي كان يُداعب خيال الشاعر باستمرار طوال فترة غير قصيرة، ظل يحلم فيها ـ إلى درجة اليقين ـ بقدوم السلام والأمان: "لنْ أضربَ في أرجاءِ الوهِمِ الحيْرانِ سأعودُ لداري فرِحاً ذات مساءٍ نشوانْ وستُفرِخُ أطيارُ الحبِّ على نافذتي وستشدو .. ذات مساءٍ نشوانْ : عمَّ الكونَ سلامٌ وأمانْ عمَّ الكونَ سلامٌ وأمانْ".(من قصيدة "هموم شاعر أشبيلية العاشق") وإذا كان هذا الحلم يبدو "طوباويا" ساذجا، ينقض ما أشرنا إليه من قبل عن "الواقعية المثالية" لدى الشاعر، فإنه في قصائد أخرى يتشكل وفقاً لقانون التضحية والفداء، وهو يُعلن عنه بخطابية مباشرة: "أقفُ وأحميكِ من السِّفْلةِ والأوغادْ وأُقدِّمُ عمري قُربانا حتى ترتسمَ على أوجهِ أطفالكِ بسماتُ الأعيادْ ويظلُّ الشعرُ رسولاً للإيمانْ سيفاً في الأرزاءْ أنزفُهُ كلَّ صباحٍ ومساءْ منْ أجلِ بنيكِ الفقراءِ الشرفاءْ" (ختام قصيدة "وشم على ذراع مصر") (يتبع) |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 2 | |||
|
حديث الوردة .. حديث النار (2 ـ 4) |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 3 | |||
|
حديث الوردة .. حديث النار (3 ـ 4) |
|||

|
|
|
رقم المشاركة : 4 | |||
|
حديث الوردة .. حديث النار (3 ـ 4) |
|||

|
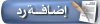 |
|
|









 العرض العادي
العرض العادي

